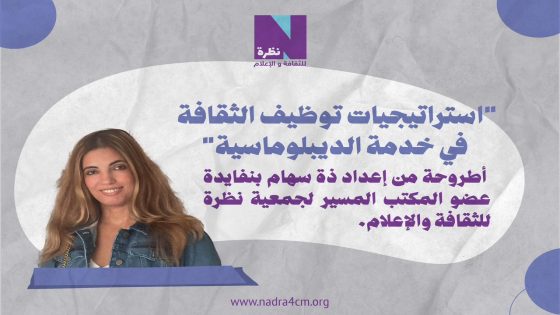يعد الظهير الشريف أسمى قانون تنظيمي بعد الدستور في تراتبية القوانين المنظمة للشأن العام.
و في الصيد البحري ناذرا ما يتم الاستناد الى قوانين قطاعات أخرى ذات الصلة لتأطير إشكاليات معينة كحماية الثروة السمكية والمحافظة عليها و على النظم الايكولوجية ،و هو ما يطرح إشكالية أخرى حول الالتقائية والحكامة.
الشاهد من خلال هذه المقالة، هو ما يعيشه قطاع الصيد البحري من تخبط بسبب تمركز القرار بيد السلطة الوصية على قطاع الصيد البحري الذي يحاك و ينسج مع ما يسمى بالتمثيليات المهنية في الصيد البحري تحت بند ”و بعد استشارة الغرف أو استنادا إلى محاضر الاجتماعات، و التي غالبا ما تكون قرارات معيبة ب “تضارب المصالح”.
والمغرب من خلال السلطة الوصية على قطاع الصيد البحري، و في شخص وزير الفلاحة و الصيد البحري و في جميع الخرجات الإعلامية و خلال المؤتمرات الدولية و المنتديات الوطنية، دوما ما يؤكد على انخراطه في الاقتصاد الأزرق كخيار استراتيجي من أجل تنمية مستدامة. إلا أن أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي كمؤسسة دستورية و استشارية و هي التي أصدرت تقريرها بعنوان الاقتصاد الأزرق.. ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب، لفت الانتباه إلى وجود كوابح لهذا التوجه و على رأسها غياب الالتقائية ، حيث أكد في لقاء نظم بالقنيطرة في أبريل الماضي أن الفضاء البحري للمغرب، الذي يزخر بثروة سمكية وموارد متجددة كبيرة، يتطلب التقائية فعلية للسياسات العمومية القطاعية التي من شأنها تحرير قدرات خلق الثروة وفرص الشغل، وتثمين إمكانات القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية.
وهنا سنقف قليلا ….لنعيد قراءة تصريح السيد رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و هو يخص الفضاء البحري للمغرب بالحديث. هذا المجال الذي تتشارك فيه قطاعات أخرى كالصيد البحري و تربية الأحياء البحرية والسياحة والمياه والغابات وقطاع الموانئ والملك العمومي البحري والبحث العلمي والتعدين والطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى أم الوزارات، وحتما وجود وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية والعسكرية …… يتطلب التقائية فعلية للسياسات العمومية القطاعية، بمعنى أن هذا الفضاء المشترك يتطلب إعداد سياسة مندمجة وتشاركية من حيث الأعداد تحقق أهداف التنمية المستدامة .
و هو ما حرك رئيس الحكومة لتفعيل هذا الورش الاستراتيجي التنموي من خلال البرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق ، بقيادة وزارة الاقتصاد والمالية و ثمانية وحدات تنفيذية، ويتعلق الأمر بقطاع الصيد البحري والجمعية المغربية لهندسة السياحة وقطاع التنمية المستدامة والمكتب الوطني المغربي للسياحة والوكالة الوطنية للمياه والغابات ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.حيث ستؤمن وحدة إدارة البرنامج التنسيق العمودي وتنفيذ الأنشطة على الصعيد الجهوي، من خلال التعاون بشكل وثيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية.
إلى هنا يبدو المشهد أكثر وضوحا من أجل الترافع بقوة و بموضوعية عن استدامة الثروة السمكية و حق الأجيال القادمة من المقدرات الطبيعية لبلادنا في المجال البحري، و عندما نقول حق الأجيال ليس فقط الاجيال من مجتمعات الصيد البحري أو ورثة المجهزين و ملاك السفن، بل أبناء هذا الوطن برمته. وبعيدا عن قانون 1919 و 1973 و استراتيجية أليوتيس الذي عادة ما تستند عليه السلطة الوصية على قطاع الصيد البحري ، سنجد أن من بين المراجع المتقدمة في تأطير التنمية المستدامة و المحافظة على البيئة (بما فيه البيئة البحرية) القانون رقم 12-99. فقد أصدر جلالة الملك محمد السادس نصره الله ظهيرا شريفا رقم 09-14-1 صادر في 4جمادى الاولى1435 الموافق لسادس مارس 2014، بتنفيذ القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة، يحدد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة و التنمية المستدامة، و الدولة هنا بمفهومها العام الذي يشمل جميع مكوناتها، من مؤسسات عمومية و خاصة ومجتمع مدني ومواطنين ، على اعتبار أن الموارد الطبيعية و الأنظمة البيئية و التراث التاريخي ملك مشترك للأمة ، تكون موضوع حماية و استصلاح و تثمين على أساس تدبير مندمج و مستدام.
و من جملة هذه الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون و التي تتعلق بالمجال البحري نجد:
– تعزيز حماية الموارد الطبيعية و التنوع البيولوجي والموروث الثقافي و المحافظة عليها و الوقاية من التلوثات و الايذايات و مكافحتها،
ـ إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.
ـ ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الإتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
ـ تعزيز الاجراءات الرامية إلى التخفيف وإلى التكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر.
– إقرار الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والاقتصادي والمالي والثقافي في ميدان الحكامة البيئية.
– تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية و المؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
– إرساء نظام للمسؤولية البيئية ونظام للمراقبة البيئية
المثير للاهتمام أن هذا القانون، و في عدد من المواد، يتخذ طابع الإلزامية و الوجوب، ما يجعله سندا شرعيا للتحاجج والترافع في ظل شطط بعض القرارات و جورها. و من جملة هذه النصوص على سبيل المثال ما جاء في المادة 2 من القانون حيث أكد المشرع على وجوب التقيد بعدد من المبادئ، ( الاندماج، الترابية، التضامن، الاحتراز، مبدأ الوقاية ، المسؤولية، و المشاركة )، حين إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة ومن قبل باقي الأطراف المتدخلة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
-فمبدأ الاندماج حسب القانون : يتمثل في تبني مقاربة شمولية وبين- قطاعية وأفقية عند إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات و برامج مخططات التنمية على المدى المتوسط والمدى البعيد.
–مبدأ الترابية: يقتضي الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي ولا سيما الجهوي، بهدف ضمان تمفصل أفضل للتدابير المتخذة من قبل مختلف المستويات الترابية لاتخاذ القرار وتشجيع تعبئة الفاعلين الترابيين لصالح تنمية بشرية مستدامة ومتوازنة للمجالات.
–مبدأ التضامن: يساهم التضامن كقيمة وموروث متجدر داخل المجتمع في التماسك الوطني، فهو يتيح في بعده الثلاثي: الإجتماعي والترابي والمشترك بين الأجيال، الرفع من قدرات البلاد على الحد من الهشاشات وتشجيع الاستعمال العقلاني والمقتصد والمتوازن للموارد الطبيعية والفضاءات.
–مبدأ الإحتراز: يتمثل في اتخاذ تدابير ملائمة و فعالة و مقبولة اقتصاديا واجتماعيا ، لمواجهة الأضرار البيئية المفترضة الخطرة أو التي لا رجعة فيها أو مخاطر ممكنة ، ولو في غياب اليقين العلمي المطلق حول الآثار الحقيقية لهذه الأضرار والمخاطر.
–مبدأ الوقاية: يتمثل في وضع آليات التقييم والتقدير المنتظم لآثار الأنشطة التي يحتمل أن تلحق ضررا بالبيئة واقتراح وتنفيذ تدابير ملموسة لإزالة هذه الآثار أو على الأقل التخفيف من انعكاساتها السلبية.
–مبدأ المسؤولية: يقتضي التزام كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص بإصلاح الأضرار التي سيلحقها بالبيئة.
–مبدأ المشاركة: يتمثل في التشجيع والتحفيز على المشاركة الفعلية للمقاولات وجمعيات المجتمع المدني والسكان في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
أما المادة 3 فقد منحت فسحة معتبرة من الحقوق لكل مواطنة و مواطن، في المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة ، باعتباره (المواطن) جزءا من الدولة ، كما أن الدولة و من خلال المادة 19 من القانون 12-99 تلتزم بضمان مشاركة السكان في اتخاذ القرار المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة والولوج إلى المعلومة البيئية طبقا للقوانين الجاري بها العمل. بمعنى أن التداول في الشأن البيئي البحري و المتعلق بالمحافظة على الثروة السمكية و استدامتها ، هو شأن عام ويؤطره القانون ، وليس امتيازا حصريا على جهة معينة كما هو الشأن في الصيد البحري، و يتخذ طابع القدسية تحت غطاء استراتيجية أليوتيس.
و من خلال هذا القانون الدسم في محتواه و الذي نجد بين تفاصيله جزء من حل الأزمة التي يعيشها قطاع الصيد البحري ، سيكون أمام جميع الفاعلين و الفعاليات أن يتحملوا مسؤوليتهم لإنقاذ قطاع الصيد البحري و انتشاله من بين براثن جهات التحكم، و الاحتكام الى العقل و المنطق و الحكمة و التحلي بالتجرد ونكران الذات ، و نفض “الشكامة” عن قيم المواطنة و استعمال الصلاحيات بما يخولها القانون.
فالثروة السمكية هي ملك للأمة، باعتبارها جزء من الأمن الغذائي وشكلا من أشكال الأمن القومي و السيادة الوطنية ، و واجب المحافظة عليها بجميع الوسائل المشروعة أمر لا يحتاج الى تأشير ، كما هو منصوص على ذلك في الدستور. و من مستوى أعلى، و لأن المجال البحري يغطي أكثر من ثلاثة ارباع الكرة الارضية ،فهو مجال مشترك بين الأمم ، و بالتالي فالثروة السمكية هي ملك للإنسانية، و في هذا السياق و المغرب يحتفي بأسبوع المحيطات ستكون المناسبة شرطا للتذكير بأن المغرب طرف في العديد من الاتفاقيات و البرامج و المبادرات الدولية التي تهدف الى حماية المحيطات و النظم البحرية والتنمية المستدامة.
الإستدامة بحسب القانون رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة ، يراد بها مقاربة للتنمية ترتكز على عدم الفصل بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية للأنشطة التنموية، والتي تهدف إلى الإستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بمقدرات الأجيال المقبلة في هذا المجال، كقيمة أساسية تتطلب من كل مكونات المجتمع إدماجها ضمن أنشطتها، حيث يعتبرها المشرع سلوكا ملزما لكل المتدخلين في مسلسل التنمية الاقتصادية والأجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد، حيث يعد قطاع الصيد البحري من القطاعات التي تتوفر على إمكانية عالية للإستدامة وتكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التقيد بالتنمية المستدامة، حسب المادة 12 من القانون..
إن ما يثير الاهتمام في القانون رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة، هو ما جاء في المادة 28 بخصوص التحفيزات الممنوحة من طرف الدولة المتعلقة بالبيئة و التنمية المستدامة، و كذا برامج البحث و التنمية ، في شكل إعانات و إعفاءات جزئية أو شاملة من التعريفات الجمركية والرسوم والضرائب والقروض طويلة الأمد والقروض ذات الفائدة المنخفضة وكل تدابير التحفيز التي يمكن للدولة منحها للقطاعات ذات الأنشطة التي تستجيب لأهداف هذا القانون-الإطار، و إخضاعها للمتابعة والمراقبة والمحاسبة، مع إحداث صندوق وطني للبيئة والتنمية المستدامة تخصص موارده لتمويل التدابير التحفيزية المالية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، وكذا لدعم كل العمليات والمبادرات المتجددة التي تساعد على التنمية المستدامة ومواكبة المقاولات.
أما فيما يخص قوة الردع ، فالمشرع لم يغفل عن ضرورة تضمينها في القانون الإطار ، و ذلك من خلال المادة 30 التي تنص على إحداث نظام جبائي بيئي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على الأنشطة المتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية، تطبق على كل سلوك فردي أو جماعي يتسم بإلحاق الضرر بالبيئة ويخل بمبادئ وقواعد التنمية المستدامة، حيث تحدد بمقتضيات تشريعية قواعد تنظيم وسير وكذا توزيع موارد هذا النظام بين الدولة والجماعات الترابية المعنية.
إن موضوع الاستدامة في قطاع الصيد البحري لم يتجاوز في مفهومه طرق المحافظة على الثروة السمكية حصرا دون اعتبار للاستدامة الاقتصادية و الاجتماعية و الإيكولوجية، ولأن كانت السلطة الوصية على القطاع قطعت أشواطا خلال العشرية الماضية في تنزيل استراتيجية أليوتيس، فيمكن اعتبار المرحلة هي فقط مرحلة تنظيم أنشطة الصيد البحري وتأطيرها بعد عقود من العشوائية ، إلا أنه و مع ما استجد من تطورات على المستوى الماكرو-اقتصادي و الجيو-استراتيجي و الإيكولوجي، يستوجب على صناع القرار تحيين الترسانة القانونية في قطاع الصيد البحري و ملائمتها مع قانون 12-99 الذي يبدو أسمى من حيث التراتبية مع القرارات التي ستصدر بعد استشارة الغرف.