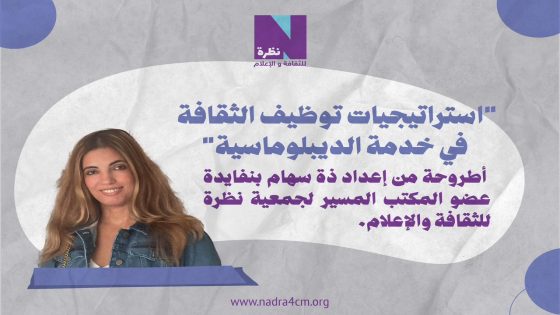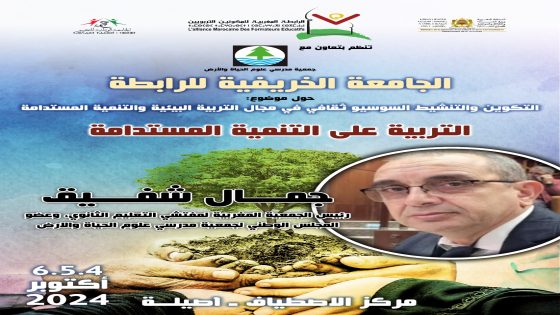تعتبر المناطق الرطبة من النظم البيئية الحيوية التي تلعب دورا مهما في الحفاظ على التوازن البيئي، حيث تساهم في توفير المياه الجوفية، تنظيم الطقس، دعم التنوع البيولوجي، والحد من التلوث.
في المغرب، توجد العديد من المناطق الرطبة التي تستدعي اهتماما قانونيا خاصا نظرا للتحديات التي تواجهها في ظل تداخل الأنظمة العقارية وتعدد الفاعلين في تدبيرها. هذه التحديات تتجسد في الأضرار التي تلحق بهذه النظم البيئية، مما يطرح ضرورة مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لحمايتها.
يشهد القانون المغربي بعض النقائص في معالجة قضايا البيئة بشكل عام، والمناطق الرطبة على وجه الخصوص، حيث يفتقر النظام القانوني في الكثير من الأحيان إلى آليات فعالة لمعاقبة الأضرار البيئية، سواء في إطار المسؤولية المدنية أو الجنائية.
المسؤولية المدنية المترتبة عن الأضرار بالمناطق الرطبة
إن قانون الالتزامات والعقود المغربي، مثله مثل أغلب القوانين المدنية، بحيث يبدو أنه غير مؤهل لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البيئة بصفة عامة والمناطق الرطبة على وجه الخصوص، باستثناء بعض المقتضيات التي يمكن الاستعانة بها في هذا المجال، ويتعلق الأمر بالفصلين 91 و 92 الذين يكرسان بكل وضوح النظرية المشهورة في القانون المقارن والمعروفة بنظرية أضرار الجوار.
إن هذه النظرية غير كافية في مجموعها لحماية البيئة بصفة عامة والمناطق الرطبة على وجه الخصوص. وترجع فائدتها المحدودة إلى عدة أسباب نذكر من بينها:
– إن مفهوم الجوار يبدو ضيقا بالنسبة لمفهوم البيئة.
– الطابع الجزئي للأضرار بالجوار.
المسؤولية الجنائية عن الإضرار بالمناطق الرطبة
إن الحماية الجنائية للعناصر البيئية، تبدو في بعض الأحيان غير مقبولة اجتماعيا، لأن المجتمع يري في القانون الجنائي، أداة مخصصة لحماية بعض القيم التي لا تشير أي نقاش مثل الشرف، الأموال، الأشخاص، ويرجع ذلك إلى كون الجريمة الإيكولوجية لم تترسخ بعد كما ينبغي في الوعي الاجتماعي، إضافة إلى أن هذا النوع من الجرائم يفسر على أنه لم يصدر عن سوء نية، وبالتالي لا يستحق أي عقاب. لكن ذلك لا يمنع من وجود مجموعة من الأدوات الزجرية المطبقة في مجال البيئة في كل البلدان.
غير أنه من الملاحظ بالنسبة للمغرب، هو أن العناصر البيئية لم تحظ بما تستحقه من اهتمام في إطار القانون الجنائي المغربي باستثناء بعض الإشارات القليلة المدمجة في إطار الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال وكذا المخالفات بمختلف درجاتها، وهذا النقص لا يمكن تعويضه إلا بالرجوع إلى القوانين القطاعية التي تتميز بتعددها.
ولقد ترتب عن تعدد القوانين القطاعية تعدد أيضا على مستوى التجريمات وعلى مستوى المتدخلين، مما أثار عدة مشاكل، ناهيك صعوبة ضبط عناصر الجريمة الايكولوجية. وبالتالي طرح مجموعة من الصعوبات يرتبط بعدم تحديد السلوك المجرم او بتعدد التجريمات وبالمسؤولية الخطئية وبالمسؤولية الجنائية وبالتقادم والمصالحة.
——————————————–
المراجع المعتمدة:
– القانون الجنائي المغربي
– قانون الالتزامات والعقود المغربي
– REMOND-GOUILLOUD (Martine), du droit de détruire, essai sur le droit de l’environnement, PUF, Paris 1989 .