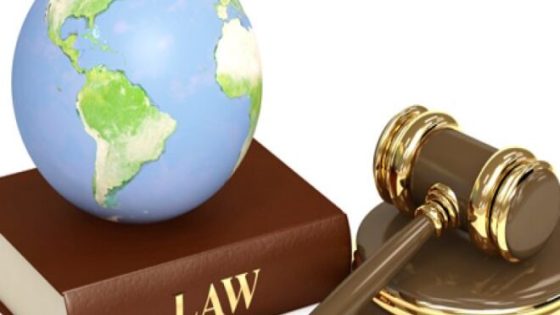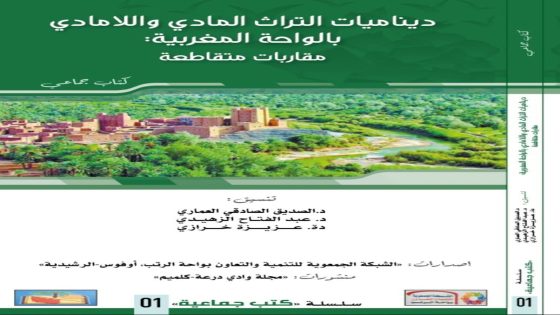(الجزء الأول)
كل نشاط يؤدي إلى الإضرار بالبيئة أو الاعتداء على عناصرها، فإن محدثه يعد مسؤولا أمام القانون عن تصرفاته الضارة بالموارد البيئية ، وما يمكن ملاحظته في هذا الشأن هو أن خصوصية الأضرار البيئية تطرح عدة صعوبات في تحديد أساس المسؤولية في هذا المجال و مدى كفاية هذه الأسس لتغطية كافة الأضرار البيئية، و صعوبات تحديد صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض عنها، مع اعتماد الفقه الحديث على مبدأ المسؤولية التضامنية في تحديد المتسبب للأضرار البيئية.
سأحاول من خلال هذا العرض تسليط الضوء على نظرية الخطأ، في تحديد المسؤولية عن الضرر البيئي سواء من خلال الأساس التقليدي القائم على نظرية الخطأ(الفقرة الأولى)، أو الأسس الحديثة القائمة على انعدام الخطأ(الفقرة الثانية)، مع توضيح مدى إمكانية القول بالمسؤولية التضامنية من خلال التحليل، في حين سنخصص مقالا أخر للتطرق للمسؤولية التضامنية في المجال البيئي بشكل منفصل عن هذا المقال.
الفقرة الأولى: المسؤولية القائمة على أساس الخطأ
كانت المسؤولية الدولية قديما مسؤولية جماعية، تقوم على أساس التضامن المفترض بين كافة أفراد الجماعة، التي وقع الفعل الضار من أعضائها، ففي تلك الفترة كان من شأن فعل من أحد الأفراد المكونين لجماعة معينة يسبب ضررا لأحد أفراد الجماعة الأخرى، وأن يصبح جميع الأفراد المكونين للجماعة الأولى مسؤولين بالتضامن عن تعويض هذا الضرر، وظل هذا الوضع مطلقا في سائر الدول الأوروبية حتى أواخر القرن السابع عشر إلى أن حدث تطور آخر، وذلك بابتكار نظرية جديدة محل نظام التضامن المفترض وهي نظرية الخطأ.
إن نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية تعد أول ركيزة ارتكزت عليها المسؤولية المدنية سواء في القوانين الداخلية أو على مستوى القانون الدولي، وهي مسؤولية تقوم على الاعتبار الشخصي لا الموضوعي وذلك بتوافر عنصر الخطأ، فإذا ترتب على هذا الخطأ ضرر للغير التزم المسؤول عنه بالتعويض، وقد أصبح مجال منازعات التلوث البيئي الأرض الخصبة لتطبيق نظرية المسؤولية التقصيرية الخطيئة.
إن الخطأ البيئي بشكل خاص لا يختلف عن الخطأ في إطار المسؤولية التقصيرية، فهو السلوك المنحرف الذي يقترفه الملوث بفعل أو بامتناع عن فعل وإدراك مرتكب الفعل الضار البيئي للانحراف الذي قام به.
لهذا فإن إتيان شخص ما فعلا مخالفا للقوانين البيئية المعمول بها بخصوص حماية البيئة يعد خطأ بيئيا وهذه المخالفة سواء كانت عمدية أو غير عمدية يبقى مرتكبها مسؤولا تجاه الإدارة الساهرة على حماية البيئة عن تعويض الضرر الذي تقدره دون أن يقع على عاتقها إثبات نية مرتكب الضرر ولكن إذا ثبت نية الاضرار بالبيئة يمكن أن يكون ظرفا مشددا للمسؤولية، فتستطيع المحكمة أن تكون أكثر تشددا مع مسبب الفعل الضار المقصود، و أكثر سخاء في تقدير التعويض.
ويتمثل السلوك المنحرف المعتمد للشخص في ميدان التلوث البيئي بإقدام الشخص على أفعال تضر بالأشخاص أو البيئة التي حولهم. ولا يهم صفة الشخص الذي ارتكب الفعل الضار، فقد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا. حيث ترفع الدعوى البيئية عادة في وجه المؤسسات والشركات الملوثة التي تقوم بإنتاج مواد ذات تأثير مباشر على صحة الإنسان او البيئة من حوله، وقد يصدر الفعل الضار بالبيئة عن أشخاص الدولة.
بالإضافة إلى هذا يمكن للخطأ أن يكون مشتركا ويستوجب تعويضا تضامنيا، وهذا ما جاءت به المادة 34 من القانون 28.00 (كل شخص طبيعي أو معنوي يودع او يستودع نفايات خطرة لدى شخص طبيعي أو معنوي غير مرخص له بذلك يعد مسؤولا بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار الناجمة عن هذه النفايات).
وجاء أيضا في المادة 97 في فقرتها الأخيرة من الباب الخامس من القانون رقم 40.13المعتبر بمثابة مدونة للطيران المدني أنه:(إذا نتجت الأضرار عن خطأ مشترك صادر عن مشغلي طائرتين أو عدة طائرات أو عن مأموريهم؛ اعتبر كل واحد من المشغلين المذكورين مسؤولا اتجاه الآخرين عن الضرر اللاحق باعتبار نسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبه كل واحد منهم).
ومن خلال هذه الفقرة يتبين أن الضرر الناتج عن خطأ مشترك يستلزم تشطير المسؤولية ويلزمهم بالتضامن بينهم حسب جسامة الخطأ. وهنا يطرح التساؤل هل يمكن أن نعتبر تشطير المسؤولية مسؤولية تضامنية بما تحمله الكلمة من معنى أو التشطير هو جزاء المسؤول في إحداثه للضرر؟
أما بالنسبة لعنصر الضرر البيئي في قيام المسؤولية لا يطرح أي إشكال في المجال البيئي(1)، لكون أن أغلب الالتزامات والأوامر التي وضعتها القوانين البيئية تترتب على مخالفتها من طرف الشخص قيام مسؤوليته، بغض النظر عن تحقق الضرر من عدمه، والأمثلة كثيرة في القوانين البيئية؛ نشير إلى بعضها على سبيل المثال وليس الحصر، ما جاء به القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء(2) المادة 4 ” يحظر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو الأكالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة …”، مما يتبين أن المسؤولية تتحقق بمجرد القيام بالفعل دون انتظار الضرر الذي سيؤول إليه. وإن كان من الممكن قيام المسؤولية بدون اشتراط ثبوت الخطأ في الفعل الضار، فلا يتصور قيامها بدون عنصر الضرر، إذ يعد هذا الأخير شرطا أساسيا لوجوب الضمان ومن ثم الحصول على التعويض (3).
وتقدير التعويض يكون على أساس جميع الأضرار اللاحقة بالمضرور سواء مادية أو معنوية، لأن الضرر المادي غالبا يكون منطويا على ضرر معنوي، يصيب نفسية المضرور وإن كان أحيانا غير بارز للعيان في حيثيات القرار.
كما سنلاحظ من خلال القرار التالي أن المحكمة رفعت من قيمة التعويض جراء ما أصاب المدعي من أضرار مختلفة ،حيث أقرت المحكمة التجارية بالرباط بمسؤولية شركة “ريضال” عن تصريف مياه التطهير التي ألحقت أضرار بأراضي فلاحية بضواحي الصخيرات ،ووفاة 5230 من الدواجن ،مما حملت مسؤولية الشركة وحكمت عليها بأداء مبلغ التعويض للمدعي قدره 700.000.00 درهم مع إصلاح الأضرار المحددة في الحكم ،لكن بعد ان استأنف الحكم من طرف المدعي وكذا شركة ريضال التي طالبة بالمرحلة الاستئنافية بإدخال شركة “لسامير” في الدعوى لأنها ليست وحدها من تقوم بالتصريف في تلك المنطقة وأن شركة لسامير هي المسؤولة عن الأضرار ؛وقامت احتياطيا بإدخال شركة التأمين “الملكية الوطنية “في الدعوى لأداء أي تعويض قد تحكم به المحكمة عليها ،وبعد مناقشة القضية وعرض الخبرة، أصدرت المحكمة قرار تقضي فيه على شركة ‘ريضال ‘ بأداء تعويض للمدعي قدره 901.898.00 درهم(4).
لكن ما يثير الإشكال، والذي يستوجب تبني مبدأ المسؤولية التضامنية، هو إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، والتي تواجه صعوبات سواء من حيث طبيعة أضرار التلوث والمتجلية في الطابع الانتشاري والطابع المتراخي، وفي أغلب الأحيان يكون ضررا غير مباشر؛ والتي تقف عائقا في أغلبية الأحيان في تحديد الضرر والمسؤول عنه. وصعوبات أخرى متعلقة بتعدد مصادر التلوث والتي تستوجب المسؤولية التضامنية نظرا لصعوبة تحديد المسؤول في بعض الأحيان. لذا يتوجب علينا عرض هذه الصعوبات ومدى إمكانية القول بالمسؤولية التضامنية من خلالها؟
–صعوبات متعلقة بتعدد مصادر التلوث البيئي:
لا شك أن رابطة السببية بين نشاط معين والنتيجة المترتبة عليه، لا يثير أية صعوبة، إذا كان هذا النشاط هو المصدر الوحيد لها. لكن إذا تعلق الأمر بالتلوث البيئي فإن إرجاع الضرر إلى مصدر محدد؛ يرتبط بالعلاقة السببية المباشرة، حيث يعتبر من الأمور الصعبة، لأن أغلب الأضرار البيئية توصف بأنها غير مباشرة، كما تشترك في إحداثها مصادر متعددة (5)، خاصة في المناطق التي يغلب عليها الطابع الصناعي أو التجاري. وبالتالي فإن إثبات هذه الرابطة في مثل هذه الحالات يعد أمرا دقيقا وصعبا، يثير العديد من المشاكل القانونية نظرا لتعدد الأسباب التي يمكن إرجاع الضرر إليها. ولقد أَقر القضاء الأمريكي هذه الصعوبة في قضية “victenam retenans” ضد سبع شركات منتجة لمبيدات كيميائية كانت لها تأثيرات على الصحة، وأوضح القضاء أن العجز الحقيقي الذي واجه المدعين هو تقديم دليل مقبول لرابطة السببية بين هذه المبيدات الكيميائية والأمراض العديدة التي يعانون منها.
كما أن إثبات رابطة السببية يصبح أكثر تعقيدا إذا استلزم الأمر إثبات أكثر من رابطة سببية واحدة بين كل شخص مسؤول أو مساهم في إحداث الضرر، وبين الضرر الذي حدث، والنسبة التي كانت سببا في حصول الضرر؛ بالنسبة لكل صاحب نشاط ضار ساهم في إحداثه (6). ومن ثم يجد المضرور صعوبة في إثبات هذه الرابطة بين فعل الآخرين وبين ضرر مؤكد قد لحق به، فيضيع حقه في التعويض نتيجة لذلك.
وأمام هذه التعقيدات اقترح الفقه الحديث مبدأ المسؤولية التضامنية المفترضة للقائمين
بالنشاط الملوث للبيئة. فمنتج المادة ومستعملها في نشاط معين كلهم مسؤولون عن ضرر التلوث في إطار تطبيق قواعد المسؤولية التضامنية (7)، كما تم اللجوء إلى تقسيم مسؤولية المساهمين المتعددين بنسبة ما يستخدمه كل منهم من مواد ملوثة إلى نسبة ما يستخدمه الآخرين منه، وهو ما يعرف بتقسيم المسؤولية بالنسب التقريبية للمواد الملوثة المستخدمة في إحداث الضرر.
إن مبدأ المسؤولية التضامنية عن الأضرار البيئية طبقته المحاكم الأمريكية عند تعدد الجهات المسببة للتلوث البيئي، فقد قضت الدائرة السادسة في محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية، بالمسؤولية التضامنية على ثلاث ولايات تسببت المصانع الموجودة على أراضيها، بإلحاق الضرر بمواطني الدولة الكندية، جراء الانبعاثات المتكررة من مداخن هذه المصانع، على أن يرجع المدعى عليهم بعضهم على البعض لقسمة مبالغ التعويض المحكوم بها ضدهم (8).
وأيضا قانون منع التلوث البريطاني لسنة 1971، نص على فرض مسؤولية تضامنية إذا نجم التلوث بالنفط عن مركبتين أو أكثر. ولم يكن بالإمكان تحديد المسؤول عن التلوث.
ورغم محاولات التشريعات الوطنية في تبني هذا المبدأ إلا أن ذلك لم يحل المشكلة، حيث يقضي القول بذلك، وجوب إثبات العلاقة السببية بين النشاط الخاطئ لكل من الأطراف والضرر الحاصل، وهذا هو أساس المشكلة، سواء كنا بصدد مسؤولية مدنية لأشخاص عاديين في مواجهة بعضهم البعض، أو كنا بصدد المسؤولية الدولية المدنية عن أضرار التلوث. فضلا عن أن أسباب الضرر المتعددة تتغير في بعض الأحوال من مكان لآخر، ويصبح من الصعب تحديد الطريقة التي أحدثت ضرر التلوث، مع ما يترتب عليه من عدم معرفة المساهمين في حدوثه. كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى انتفاء المسؤولية والتأثير على حق المضرور في التعويض عن ضرر مؤكد وحاصل.
ومن ثم كان الاتجاه نحو افتراض العلاقة السببية وتسهيل إثباتها، أو الاستناد إلى أَقصى ما وصل إليه العلم الحديث في إثبات الصلة بين فعل ما أو أكثر والنتيجة المترتبة عليه.
————————————————
المراجع:
1- خصوصية المسؤولية التقصيرية (ياسين الكعيوش) باحث بسلك الدكتوراه فاس؛ موقع مجلة القانون والأعمال.
2- الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19يونيو2003)، ص 1912.
3- نصر الدين محمد، أساس التعويض في الشريعة الاسلامية والقانون المصري؛ رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة سنة 1983 ص/38.
4- ملف تجاري عدد01.03.2012/500 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالرباط والمؤرخ في 20.03.2014 غير منشور.
5- محمد عبد الظاهر حسين، خطأ المضرور وأَثره على المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، مصر سنة 2002، ص 25
6- نبيلة إسماعيل رسلان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007ص 205.
7- -Jacque Pourciel, Protection de l’environnement de la contraint au contrat, Tome 1, 1994,p34
8- قضية: (Mitchie .V.Great lakes .steel )