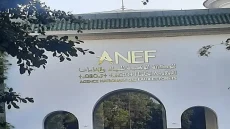اعتمد المغرب مقاربة قانونية لحماية البيئة، ترتكز على تدخل الدولة في تدبير المخاطر البيئية والمحافظة على الفضاء البيئي، وحمايته بموجب مقتضيات قانونية، تتضمن تدابير وآليات توجيهية وضبطية، ومقتضيات زجرية وإحداث أجهزة ومؤسسات عمومية، وأخرى خاصة تعنى بحماية البيئة.
ولأن البيئة تعد من القيم التي سعى المشرع لحمايتها والحفاظ عليها، فقد أضفى على هذه الأخيرة حماية جنائية والتي تعتبر من أبرز تجليات الحماية القانونية للبيئة، بالنظر لما للجزاء الجنائي من أثر ردعي وزجري.
وبالقيام بقراءة تحليلية لمعظم النصوص البيئية ذات الصلة المباشرة بحماية البيئة نجدها تميل لما هو إداري، أكثر مما هو جنائي. بالرغم شمولها بحماية جنائية.
هناك العديد من المجالات المشمولة بالحماية الجنائية، أذكر منها، حماية واستصلاح البيئة؛ دراسة التأثير على البيئة؛ تدبير النفايات والتخلص منها؛ القطاع الغابوي؛ التعمير؛ التجزئات العقارية والمجموعات السكنية؛ مكافحة تلوث الهواء؛ المجال المائي…
وسنخصص هذا المقال، لمجال الماء، من خلال قراءة لمضامين قانون الماء 36.15، خاصة النصوص المتعلقة بالعقوبات الزجرية وتكييفها مع أحكام القانون الجنائي، لكي نحاول أن نخلص هل قانون الماء ذو طبيعة إدارية، أم ذو طبيعة زجرية جنائية؟ هذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال قراءتنا لقانون الماء، بناء على تصنيفات الجرائم ودرجاتها في القانون الجنائي(أولا)، وأيضا تكييفها(ثانيا)، والجانب الإجراء أيضا من خلال، الجهاز المكلف بمراقبة المخالفات المنصوص عليها في قانون الماء والمحكمة المختصة بالنظر في هذه المخالفات(ثالثا).
أولا: من حيث تصنيف الجرائم
تصنف الجريمة إلى ثلاث من حيث الخطورة ومن حيث الطبيعة ومن حيث الأركان.
فبالنسبة لطبيعتها، تعتبر من الجرائم العادية، وما يهمنا هو تصنيفها من حيث الخطورة وأيضا من حيث الأركان.
1- من حيث الأركان :
– الركن المادي:
تختلف طبيعة الأعمال المكونة لهذا الركن حسب صنف الجريمة، ففي الجرائم الشكلية أو جرائم السلوك، يتمثل الركن المادي، في صورة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يحذره القانون بصرف النظر عما قد يترتب عنه من نتائج. أما في جرائم النتيجة، فلتحقق الركن المادي لابد من إتيان فعل وتحقق نتيجة إجرامية ووجود علاقة سببية بينهما.
ومنه يمكن القول مبدئيا، أن الجرائم المنصوص عليها في قانون الماء، هي جرائم شكلية وليس جرائم النتيجة. وذلك راجع إلى كون النصوص كلها لا تنص صراحة على تحقق النتيجة لكنها تعاقب على ارتكاب الفعل الممنوع.
ويهتم القانون الجنائي بالفعل الضار الذي يصيب المجتمع ويترتب على ذلك قيام مسؤولية الفاعل الجنائية، وفي القانون 36.15، نجده من جهة يحظر الأفعال التي قد تسبب في تضرر الملك العمومي المائي، وفي جهة مقابلة نجده يبيح هذه الأفعال في إطار رخصة. وبالتالي نلاحظ أن القانون ينظم استغلال الماء وليس حماية الماء بصفته ملكا مشتركا.
– الركن المعنوي
يتمثل الركن المعنوي، في انصراف إرادة الشخص إلى ارتكاب جريمة معينة، فالفعل، أو الامتناع المخالف للقانون، ينبغي أن يصدر عن الفاعل وهو على بينة واختيار من تصرفه وعلمه بالواقعة المقبل عليها من الناحية المادية والقانونية. غير أن الأفراد قد يرتكبون جرائم خطأ، وهي جرائم غير عمدية، لكنها تقترف عن طريق الإهمال، أو عدم التبصر، أو الاحتياط، أو عدم مراعاة النظم والقوانين.
وفي قانون الماء نجده أغفل هذا الركن بشكل واضح حيث لم يميز بين الجرائم العمدية والغير العمدية باستثناء ما ورد في المادة “144 ”، في الفقرة “3” ((الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع عن قصد …))، والمادة “145 ” ((… كل من عمد إلى جلب مياه …)). لكن لم يحدد المشرع، طبيعة مخالفة المواد الأخرى هل هي على وجه العمد أم على وجه الخطأ.
– الركن القانوني
إن تصرفات الفرد لا يعاقب عليها، إلا إذا نص القانون على تجريمها، وحدد لها عقابا طبقا لمبدأ ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص “. وعند مقارنة هذا المبدأ مع مقتضيات قانون الماء نجد أن هناك قصور من جانب المشرع، بحيث نجد هناك إحالات كثيرة، مما يجعلنا أمام أكثر من نص، والذي يجعل من الصعب تحديد الجريمة المرتكبة، وبالرجوع مثلا إلى المواد ” 147 ” و” 148 “، واللتان تحيلاننا إلى المواد ” 98 ” و” 158 ”، ثم المواد ” 109 ” و” 159 ”، لا نجد أن هناك أية مخالفة منصوص عليها بشكل صريح، مما يضمن تحقق مبدأ ” شرعية التجريم والعقاب “.
2- تصنيف الجرائم من حيث الخطورة
من خلال قراءة نصوص قانون الماء يصعب تحديد تصنيفات الجرائم التي يعاقب عليها قانون الماء. حيث برجوعنا لمجموعة القانون الجنائي، نجده صنف الجريمة حسب خطورتها والعقوبات المقررة لها إلى ما يلي:
– جنايات (الفصل 16 ق.ج): وهي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع بإحدى العقوبات التالية؛ الإعدام، أو السجن المؤبد أو المؤقت، من 5 إلى 30 سنة أو الإقامة الإجبارية أو التجريد من الحقوق الوطنية.
– الجنح (الفصل 17 ق.ج): وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات تأديبية والمتمثلة في، الحبس الذي يتجاوز حده الأقصى سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات.
– المخالفات (الفصل 18 ق.ج): وهي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع بعقوبات ضبطية، والمتمثلة في الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة التي لا تزيد عن 1200 درهم .
والمخالفات في قانون الماء يمكن تقسيمها إلى:
– تجاوز نظام الترخيص
– تجاوز نظام الامتياز
– المياه المستعملة
– المياه المعدة للاستهلاك
– عرقلة مجاري المياه
– المياه السطحية او الباطني
– إنشاء منشآت وتجهيزات فوق الملك العمومي المائي
– عدم تنفيذ الالتزامات
إن كثرة الإحالات تجعل من الصعب حصر الأفعال المجرمة وأيضا يصعب تصنيفها حسب خطورتها.
وبالرجوع إلى الشق المتعلق بالعقوبات في القانون “36.15 ” لا نجده احترم التراتبية الموجودة بالقانون الجنائي، بحيث يلفظ عبارة مخالفة، بينما الجزاء لا يتناسب مع وصفها القانوني، حيث نجد بعض العقوبات المقررة هي ترقى لوصفها بجنحة وليس مخالفة، هذا ما يجعلنا نتساءل، هل السلم التي اعتمده المشرع في الجزاء، ليس نفسه السلم المعتمد في القانون الجنائي؟
كل هذه الأسئلة وغيرها تزيد من توضيح الشكوك المتعلقة بطبيعة هذه الجزاء ات التي يغلب عليها الطابع الإداري.
ثانيا: عوامل تفريد العقوبة
رغم جهل المشرع للمجرم قبل ارتكابه الجريمة، فإنه ينطلق من معطيات عامة من أجل تحديد العقوبة. حيث وضع التقسيم الثلاثي للجرائم، الجنايات، والجنح، والمخالفات. ونص أيضا على مجموعة من التدابير الوقائية، وبعض الأعذار القانونية المعفية والمخففة من العقاب، بالإضافة إلى الظروف التي ترفع من العقوبة؛ والمتمثلة في، الظروف المشددة والتعدد وحالة العود.
وبالرجوع إلى قانون الماء، نجد صياغته تجعل من الصعب جدا، التطرق إلى هذه الأسباب والظروف، لكون المشرع لم يصنف لنا الجرائم حسب خطورتها. ويمكن حصر العوامل التي تجعل من الصعب تكييف الجريمة سهلا فيما يلي:
– عدم دقة تحديد الركن المادي (لم يعتني ببيان العنصر المادي للسلوكيات المجرمة واكتفى بالإحالة الى نصوص أخرى وهذا يحول دون تحديد سلوك المجرم)
– من حيث العدد: تداخل التكييفات
– عدم تدقيق العناصر المادية للجرائم مما يفتح الباب للتوسع والاجتهاد في تفسير النص الجنائي.
– عدم النص صراحة، على القصد الجنائي، في مجمل النصوص، باستثناء المواد التي تمت الإشارة إليها سابقا.
– عدم التمييز بين الشخص الطبيعي والمعنوي والعقوبة المقررة لكل واحد منهم، بالخصوص أننا نجد موادا تتضمن عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مادية، بحيث نتساءل عن ما الجدوى بإقرار عقوبة حبسية ما دام المشرع في القانون الجنائي لا يأخذ بالعقوبة السالبة للحرية للشخص المعنوي الفصل (127) ق.ج؟
وبالنسبة لحالة العود نجد أن المشرع في صياغته جعل منه ظرفا من ظروف التشديد، مما يجعلنا نتساءل أيضا عن ” العود” المنصوص عليه في قانون الماء، هل هو نفسه المنصوص عليه في القانون الجنائي؟ حيث أن المشرع في قانون الماء لم يعطى له تعريفا ولا شروطا.
ثالثا: من حيث الجانب الإجرائي
خصص القانون رقم ” 36.15 “، المتعلق بالماء حيزا هاما لمراقبة الملك العمومي المائي. حيث أناط هذا القانون مهام المراقبة بجهاز شرطة المياه، بهدف الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث ومختلف أشكال الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، وتتدخل شرطة المياه، التي تتكون من الأعوان التابعين للإدارة، لاسيما السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، في الملك العمومي المائي الذي يتكون من جميع المياه القارية، سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة، وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الملك العمومي المائي والمنشآت المائية وملحقاتها المخصصة لاستعمال عمومي. كما يعتبر الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم. وبالرجوع إلى المادة ” 131 ” من القانون ” 36.15 ” نجده حدد لنا المكلف بمعاينة المخالفات لمقتضيات الماء، إما بالإحالة أو منصوص عليهم في قانون الماء:
1- هيئات معاينة وضبط الجرائم البيئية
– ضباط الشرطة القضائية (المادة من 25قانون المسطرة الجنائية).
– الأعوان المحلفون والمعينون من طرف الإدارة ووكالة الحوض المائي “المادة 131 من القانون 36.15″.
بالرجوع إلى المادة 27 من قانون المسطرة الجنائية نجدها تنص، ” يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص”.
فانطلاقا من هذا النص، يعترف المشرع، بإمكانية ممارسة بعض مهام الشرطة القضائية، من خارج الأجهزة المعهود إليها عادة ممارسة هذه المهام، كجهاز الأمن الوطني، والدرك الملكي، بشرط أن تبقى مزاولة هذه المهام محصورة في النطاق التي تحدده وتسمح به النصوص الخاصة لهذه الإدارة.
تم تحديد نطاق أعمال؛ ضباط الشرطة القضائية وصلاحياتهم في قانون المسطرة الجنائية، بينما الأعوان المشار إليهم في المادة ” 131 ”، من قانون الماء تتلخص مهمتهم في مراقبة التراخيص وحفر الآبار، الوديان، السدود، حماية الملك العمومي المائي، وتثمين الموارد من الثروة المائية، والحفاظ عليها من الاستعمال التعسفي.
وبالرجوع إلى المادة ” 131 ” من قانون الماء، نجدها تمنح أعوان شرطة المياه، المعينين من قبل الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات الأخرى المعنية، حق معاينة المخالفات في مجال المياه وتحرير المحاضر طبقا للتشريع المتعلق ب “أداء القسم”.
ومن الصلاحيات الموكولة إليهم، إمكانية الطلب من مالك المنشأة، التقاط أو جلب الماء أو صبه، لإعادة تشغيل هذه المنشأة، قصد التحقق من خصائصها، “المادة “132” من قانون الماء. لكن مقابل التعريف بصفتهم أولا، بواسطة البطاقة المهنية التي تسلمها الإدارة.
كما يحق لهم أخد عينات وفقا لشروط حددتها المادة ” 134 ” من نفس القانون. كما أن هذه المحاضر، تحرر طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ومنح القانون كذلك لهؤلاء الأعوان، الحق في إيقاف الأشغال، والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة، وإيداعها بالمحجز.” المادة 136 ” .
لكن السؤال المطروح هل يوجد محجز خاص بهذا النوع من المحجوزات، خصوصا وأن الآليات المعدة لهذا المجال تكون باهظة الثمن، ومنه نتساءل مرة أخرى، عن الضمانات التي خولها المشرع لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص، خاصة في ظل المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية ” 22.01 “.
كما نتساءل أيضا عن، مدى مساعدة الآليات، والظروف المجتمعية، لهؤلاء الأعوان في ممارسة أعمالهم، خاصة أمام جهل المواطنين لوظيفتهم، الراجع إلى ضعف التحسيس بمهامهم. وهنا نشير إلى الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في التحسيس والتوعية والإرشاد، وخاصة الإعلام البيئي الذي يجب أن ينشر مقالات متخصصة في العديد من المجالات البيئية، وتقريبها للمواطن لفهم ما هو قانوني، وجعله يحترم البيئة بمكوناتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. بالإضافة إلى ضعف الأدوات اللوجيستيكية التي تحول دون القيام بمهامهم بشكل جدي وصحيح.
2- المحكمة المختصة
تحال القضايا إلى المحكمة المختصة نظرا لأن النص يزاوج ما بين الاختصاص الإداري والزجري.
حيث نجد أن المشرع في المادة ” 153 ” من قانون الماء، أشار إلى إمكانية تنصيب وكالة الحوض المائي، بصفتها مطالبة بالحق المدني. بالإضافة إلى لأنه تمت، الإشارة إلى مسطرة الصلح. وكملاحظة أن مسطرة الصلح تحيلنا إلى، أن الصلح بديل للدعوى العمومية، لكن المشرع في قانون الماء، نص على الصلح بعد صدور الحكم النهائي.
وفي الختام، وبناء على كل ما سبق التطرق إليه، يتضح أن قانون الماء لا يحمي الماء بل يحمي استغلال المياه، مما يجعلنا نفهم أنه يحمي مصلحة خاصة وليس مصلحة عامة. إذا فالقانون يزاوج بين ما هو إداري وما هو زجري، مما يجعلنا نتساءل: هل طبيعة القوانين البيئية كلها تهدف إلى حماية المصالح الإدارية فقط؟
يمكن أن تكون الإجابة بنعم في حالة ما اعتبرنا أن قانون حماية البيئة يصنف بصفته فرعا من فروع القانون العام، لكونه ينظم العلاقة بين الإدارة والأفراد أكثر مما ينظمها فيما بينهم. أما إذا صنفناها من ضمن فروع القانون الخاص وأضفينا لها حماية جنائية، فيجب على المشرع أن يعيد النظر في صياغة نصوصه التشريعية في مجال حماية البيئة وجعلها تتماشى مع قواعد القانون الجنائي.
المراجع :
– ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 )10 أغسطس 2016(بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، – الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، ص 6305.
– ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، 1 – الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315.
– ظـهير شـريف رقم 1.59.413 صـادر في 28 جمـادى الثانية 1382 )26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، 1 – الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253.