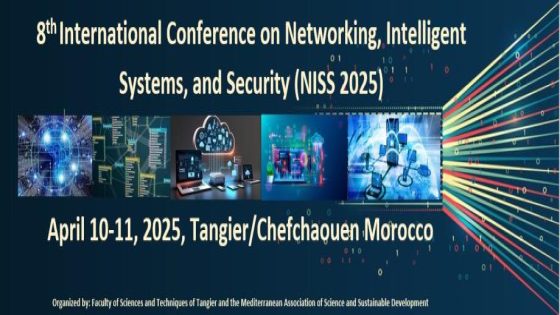هل يمكن للاقتصاد أن يساعد في حل مشاكل البيئة؟ هل تستطيع الأسواق تحديد كيفية استخدامنا للموارد الطبيعية بشكل أفضل؟ في هذا المقال، نكتشف كيف يمكن للنظريات الاقتصادية مثل توازن السوق أن تؤثر على البيئة، ونناقش التحديات التي قد تواجه هذا النظام عند تطبيقه في قضايا مثل التلوث وتغير المناخ.
تعتبر نظرية توازن السوق إحدى المفاهيم الأساسية في الاقتصاد التقليدي، حيث تركز على التفاعل بين العرض والطلب في تحديد الأسعار والكميات في الأسواق. وفي المجال البيئي، يتم تطبيق هذه النظرية لفهم كيفية تحديد العرض والطلب على الموارد الطبيعية والبيئية، مثل المياه والهواء والطاقة النظيفة. ومع ذلك، تواجه هذه النظرية تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالبيئة، نظرا للخصائص الخاصة التي تتمتع بها الموارد البيئية، كونها موارد عامة أو غير مملوكة.
تعود جذور نظرية توازن السوق إلى الفكر الاقتصادي الكلاسيكي، حيث كان الاقتصاديون مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو يعتقدون أن الأسواق تعمل بكفاءة عندما يتم تحديد الأسعار عن طريق تفاعل العرض والطلب. لكن عند تطبيق هذه النظرية على الموارد البيئية، بدأ الاقتصاديون، في القرن العشرين، يتعاملون مع الفشل السوقي-إخفاق السوق-Défaillance du marché، الناتج عن تأثير الأنشطة الاقتصادية على البيئة. في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ظهرت أفكار جديدة حول الاقتصاد البيئي، حيث بدأ العلماء يتحدثون عن كيفية استخدام آليات السوق مثل حقوق التلوث أو الضرائب البيئية لتوجيه السوق نحو توازن يستوعب القيم البيئية.
اعتماد نظرية توازن السوق في المجال البيئي
يتم تطبيق نظرية توازن السوق في مجال البيئة، بشكل رئيسي في إدارة الموارد المشتركة والسياسات البيئية، حيث تتضمن بعض التطبيقات البارزة:
– أسواق حقوق الانبعاثات، مثل تجارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون(السوق الكربوني)، حيث يتم تحديد كمية الانبعاثات المسموح بها للشركات، ويمكنها شراء أو بيع حقوق الانبعاث بناء على توازن العرض والطلب، وفي هذا الصدد نجد اتفاقية باريس للمناخ لسنة 2015 قد تطرقت لآليات تنظيم سوق الكربون من خلال المادة 6، التي تتيح للدول التعاون الطوعي لتقليل الانبعاثات وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا (NDCs). وتنص هذه المادة على إنشاء آليات لتبادل أرصدة الكربون، حيث تسمح المادة 6.2 بتبادل وحدات خفض الانبعاثات بين الدول، بينما تؤسس المادة 6.4 نظاما عالميا لتعويض الكربون عبر مشاريع خفض الانبعاثات، شبيها بآلية التنمية النظيفة في بروتوكول كيوتو. كما تشمل المادة 6.8 آليات غير سوقية مثل التعاون التكنولوجي والتمويل المناخي. وقد تم تحديد القواعد التنفيذية لهذه الآليات في اتفاقية غلاسكو للمناخ (COP26) سنة 2021، مما شكل خطوة مهمة نحو تفعيل أسواق الكربون العالمية.
– الضرائب البيئية: مثل الضرائب على التلوث، حيث تهدف إلى تعديل سلوك الشركات والأفراد ليأخذوا في اعتبارهم الأثر البيئي في قراراتهم الاقتصادية. وفي هذا الصدد نجد اتفاقية كيوتو لسنة 1997 قد تناولت الضرائب البيئية كأحد الآليات الاقتصادية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث شجعت الدول على استخدام أدوات السوق، مثل ضريبة الكربون، لتقليل التلوث وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. كما دعمت اتفاقية باريس هذه الفكرة من خلال آليات المادة 6، التي تسمح بتسعير الكربون عبر أنظمة تبادل الانبعاثات والضرائب البيئية. إلى جانب ذلك، أكدت أجندة 2030 للتنمية المستدامة على أهمية الضرائب البيئية كأداة لتحقيق الاستدامة البيئية والحد من التدهور البيئي، خاصة ضمن الهدف 13 المتعلق بمكافحة تغير المناخ.
– أسواق المياه والطاقة النظيفة: يتم تحديد الأسعار والكميات من خلال تفاعل الطلب على المياه والطاقة النظيفة مع العرض المتاح. وقد تناولت عدة اتفاقيات دولية قضايا أسواق المياه والطاقة النظيفة، حيث أكدت اتفاقية باريس على أهمية التحول نحو الطاقة المتجددة والاستثمار في حلول مستدامة عبر آليات التمويل المناخي.
كما تضمنت أجندة 2030 أهدافا محددة لدعم هذه الأسواق، أبرزها الهدف السادس الذي يسعى إلى ضمان توفير المياه النظيفة والإدارة المستدامة لمواردها، والهدف السابع الذي يركز على تعزيز الوصول إلى طاقة نظيفة وميسورة التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) الروابط بين إدارة المياه والطاقة في سياق التكيف مع تغير المناخ، فيما تساهم اتفاقية ميثاق الطاقة (ECT) في دعم الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة وتعزيز أمنها، مما يساهم في بناء أسواق أكثر استدامة وكفاءة على المستوى العالمي.
التحديات في تطبيق النظرية في المجال البيئي:
– السلع العامة والمشتركة: العديد من الموارد البيئية، مثل الهواء والمحيطات، هي سلع عامة يصعب تحديد سعر لها، و لا يمكن تقييد الوصول إليها، مما يؤدي إلى استهلاك مفرط (مثل التلوث).
– العوامل الخارجية (Externalities): غالبا ما لا تعكس أسواق الموارد البيئية التكلفة الحقيقية للآثار البيئية الناتجة عن النشاطات الاقتصادية، مثل تلوث المياه أو تدهور الأراضي. يتطلب ذلك تدخلات من الحكومة لتصحيح هذه العوامل الخارجية.
– الضبابية في تقييم القيمة البيئية- “L’incertitude dans l’évaluation de la valeur environnementale” : يصعب قياس القيمة الحقيقية للموارد البيئية مثل التنوع البيولوجي أو الهواء النقي، مما يجعل من الصعب تحديد التوازن بين العرض والطلب بشكل دقيق.
– التحفيز على الاستدامة: في بعض الأحيان، قد تؤدي الأسواق إلى تشجيع الاستهلاك المفرط للموارد البيئية على المدى القصير، مما يعوق تحقيق الاستدامة البيئية على المدى الطويل.
الانتقادات الموجهة لنظرية توازن السوق في المجال البيئي:
– عدم مراعاة العدالة الاجتماعية: العديد من الانتقادات تتعلق بعدم قدرة أسواق الموارد البيئية على ضمان العدالة بين الفئات الاجتماعية المختلفة. على سبيل المثال، قد يؤثر تلوث الشركات الكبرى على المجتمعات الفقيرة أكثر من غيرها.
– عدم القدرة على التعامل مع التحديات البيئية العالمية: تعتبر هذه النظرية غير كافية في التعامل مع قضايا بيئية عالمية مثل التغير المناخي أو فقدان التنوع البيولوجي، حيث أن الأسواق لا تعكس بالضرورة التكلفة العالمية لهذه القضايا.
– عدم أخذ الأبعاد البيئية طويلة الأمد في الحسبان: قد تركز الأسواق على التوازن القصير الأجل بين العرض والطلب، مما يعيق تبني سياسات بيئية طويلة الأجل تستهدف الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.